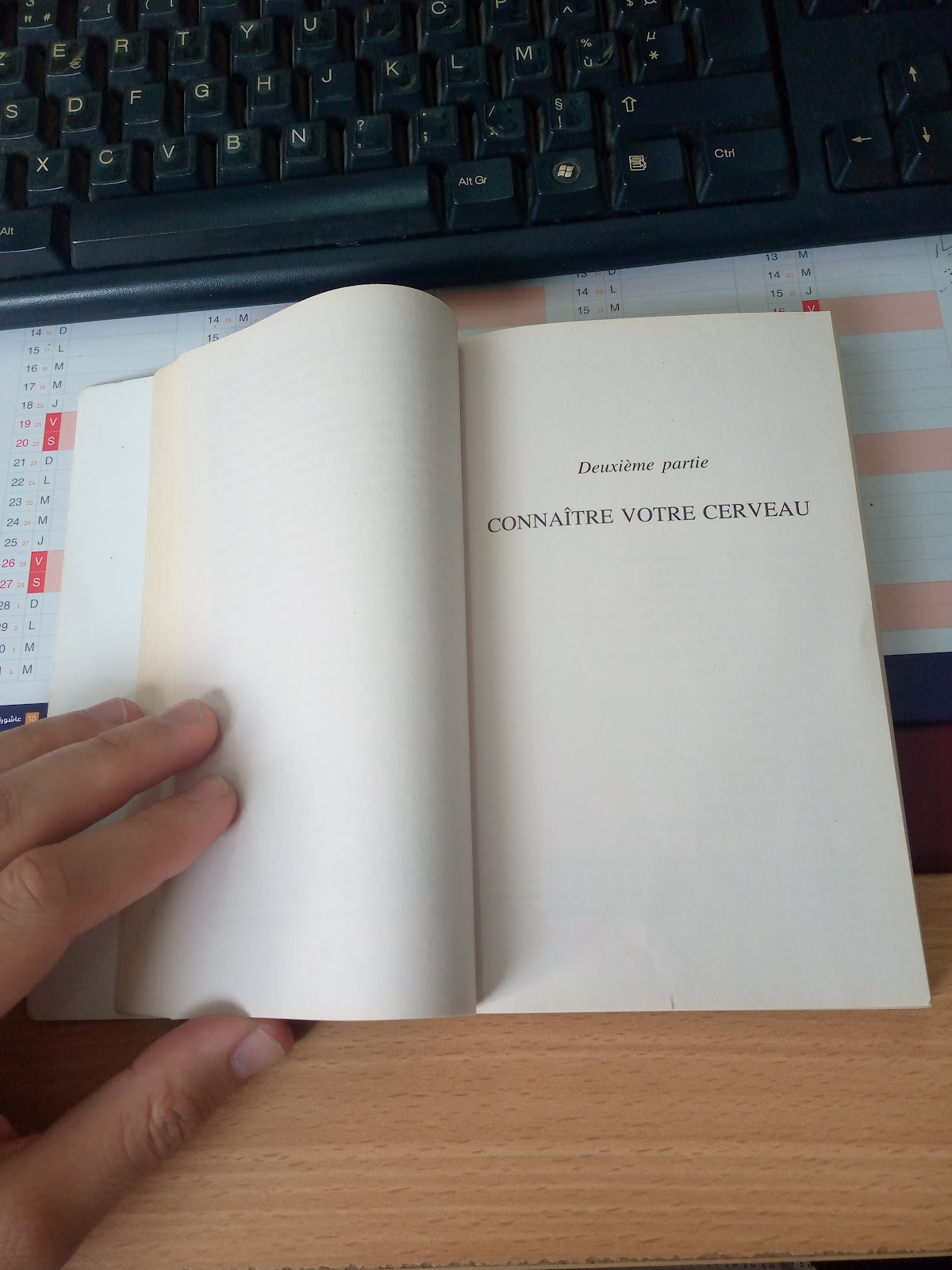جِيُوسياسة المعرفة

جِيُوسِياسَةْ المَعرِفَة. مقال مُكثّف بالمعلومات التاريخيّة، لفهم علاقة الجغرافيا السياسية مع المعرفة، بأسهل الطرق. الجيوبوليتيك عيارة عن مادة يُدرّس فيها تأثير المناطق الجغرافية، محل البلدان والتقاطعات، في السياسة المحلية والعالمية. كذلك، هي تدرس تاريخ المناطق الجغرافية والتطورات التي طرأت عليها، وانعكاس ذلك على العقيدة العسكرية، وإ إدارة المنطقة والإقليم. أما المعرفة فهو مصطلح يشمل العلوم والتكنولوجيا بكل أصنافها، فالمعرفة تعني الإحاطة بالمعارف، أي المعلومات، ومن يُحيط بالعلوم يسمى عارفاً، والمُتقن في علمٍ ما يسمى عالماً أو عارفاً كذلك، أما البلد الذي يحتضن المعارف فهو بلد متطوّر وكمثال على تأثير الجغرافيا على السياسة، وبذلك على توزيع المعرفة من تلك الأمكنة، نذكر الحضارة المينوسية، و التي أنجبت مملكة كنوسوس الإغريقية، أين يتواجد قصر مينوس الأثري، التي تُعتبر مهداً للحضارة الغربية جمعاء في العصر البرونزي، ومنطقتها في الحوض المتوسط بين اليونان وتركيا ومصر جعلها منطقة استراتيجية في التأثير المعرفي الثقافي القادم. وقد كانت نشأتها في نفس زمن الأهرامات المِصرية جنوباً، وقد كانت الحضارة الم...