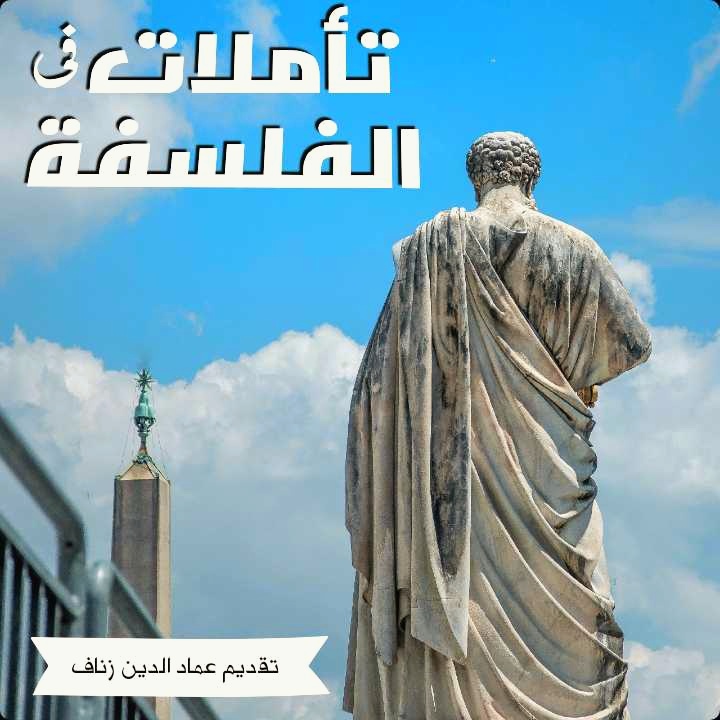إخوان الصفا، بين الإسلام والفلسفة

اربطوا الأحزمة، سنتحدّث عن لُغز إخوان الصفا، في الإسلام والفلسفة. لُغزُ "إخوانُ الصفاء" والفلسفة في الإسلام. قبل البداية في الحديث عن هذه الجماعة، لا يمكن بأي حال من الأحوال الإحاطة بالفكر الإسلامي بشكلٍ سليم، دون دراسة وإن كانت سطحية، للفكر المُعتزلي، الأشعري، الصوفي، الباطني، الجهمي، الكرّاميّ، المشّائي بكل فلاسفته كالكندي والفارابي والمعرّي وابن سينا، علمُ الكلام بأبرز من تكلّم فيه، المذاهب الأربعة وخاصة المذهب الحنفيّ بكل أعمدته كشمس الأئمة السرخسي، ولم أذكر هذا الأخير عبثاً، ذلكَ أن منوط بموضوع المقال. كل ما ذكرت في الفقرة الأولي تجدونَه على شكل مقالات مُفصّلة كنت قد صنّفتها من قبل في مدوّنتي في موقع بلوجر، ما عليكم سوى إدراج الكلمات المفتاحية داخر المدونة. لماذا علينا الإحاطة بكل تلك الأمور قبل الحديث عن الفلسفة في الإسلام، لأن وببساطة لا يجب أن نبدأ بالتفاصيل قبل الحديث عن الفترة، الظروف الزمكانية، البواعث، الأزمات، الوضع الحضاري السّائد، البُعد المعرفي، وغيرها من التفاصيل التي إذا ما كنا نجهلها، فسوف نقع لا محالة في الخلط، والتعصّب، والمناقشة السطحية لتلك المواضيع ا...